
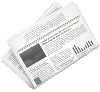
يمكن الاستعانة بنظريّات عدة لدى النظر إلى معالم سياسات دونالد ترامب وتوجّهاتها نحو الشرق الأوسط في عهده الثاني. العالم العربي، منذ عهد جون كنيدي، يُفرِطُ في توقّع الأفراح والعطايا في الولاية الثانية للرئيس الأميركي: نظنّ أنّ سطوَة اللّوبي تزول. هناك، في عالمنا من لا يزال يصدّق أنّ «الموساد» قتل جون كنيدي لأنّه كان يزمع على ضبط إسرائيل والالتفات إلى القضيّة الفلسطينية. الجزء الأول والثاني من الجملة غير صحيحَين، وليس هناك أيّ دليل أنّ كنيدي كان مهتماً بقضايانا (راجع كتاب وارن باس، «ادعم أيّ صديق: الشرق الأوسط في عهد كنيدي وتشكيل الحلف الأميركي-الإسرائيلي»). هو اهتمّ لمدة قصيرة (كتبتُ عنها من قَبل) بالتصدّي للنووي الإسرائيلي، وقضيّة اللاجئين الفلسطينيين وتحسين العلاقة مع عبد الناصر. لكنّ القوى الصهيونيّة المتنفّذة، مثل المموِّل الديموقراطي أيب فورتاس، سارعت إلى التأثير على كنيدي، فكان أن أقلع عن محاولة التصدّي لإسرائيل. انتهت القصّة عند هذا الحدّ، وغضّ النظر عن مبادرة معاينة المنشآت النووية الإسرائيلية. والنظريّة نفسها، أو أخرى مشابهة، صاحبت استقالة ريتشارد نيكسون من البيت الأبيض في عام 1974. هناك عند العرب، مَن آمن بأنّ اللوبي الإسرائيلي كان وراء افتضاح قضيّة «ووترغيت»، لأنّ نيكسون كان يريد التصدّي لإسرائيل في ولايته الثانية. مرّة أخرى: ليس هناك أيّ دليل على ذلك، ونيكسون في حرب 1973 أمر بـ«منح إسرائيل كلّ ما لدينا» لمنعِها من الانهيار في الأيام الأولى من الحرب، قبل أن يؤدّي سلوك أنور السادات إلى تحويل النصر المُبكِّر إلى هزيمة محقَّقة في نهاية الحرب؛ علماً أنّ نائب الرئيس الأميركي، سبيرو أغنيو، الذي اضطرّ إلى الاستقالة، روّج لنظرية اللوبي اليهودي لأنّه كان قريباً من المصالح الخليجية بسبب فساده المستشري وكرهه لليهود. وأغنيو، كتب للأمير فهد في عام 1980، وطلب منه معونة مالية لمحاربة الصهيونية التي تلاحقه بسبب نقده لإسرائيل، بحسب زعمه.
لم يتميّز أيّ رئيس أميركي في ولايته الثانية (عندما يُفترض، بحسب النظرية، أن يكون قد تحرَّر من سطوة اللوبي الإسرائيلي) بشجاعة في مقارعة إسرائيل مقارنةً بولايته الأولى. لم ينقص تأييد ريغان لإسرائيل في الولاية الثانية، كما أنّ كلينتون ازداد شراسة تجاه الشعب الفلسطيني في ولايته الثانية، وكذب على ياسر عرفات عندما دعاه، في آخر ولايته، إلى لقاء قمّة في كامب ديفيد، مع إيهود باراك، إذ وعده بأنّه لن يلومه لو أنّ القمّة فشلت. وعندما فشلت القمّة بسبب رفْض عرفات شروطاً مهينة للفريق الفلسطيني، سارع كلينتون إلى الميكرفون وحمّل عرفات شخصيّاً المسؤولية عن فشل القمة (وكذب كلينتون عن مضمون الاتفاق). كما أنّ جورج دبليو بوش استمرّ في دعم إسرائيل في ولايته الثانية، وباراك أوباما توصّل إلى الاتّفاق التاريخي مع إسرائيل في الولاية الثانية، والذي بناء عليه تحصل إسرائيل على 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات (غير الإنفاق الموسمي الإضافي لدعم إسرائيل وتسليحها).
والآن، أمامنا ولاية جديدة ثانية (غير متسلسلة، وهذا حدث لم يسبِق ترامب إليه إلا الرئيس غروفر كليفلند في أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر). يعود ترامب إلى البيت الأبيض بثقة أكبر وسلطات أوسع بحُكم الانتصار الانتخابي غير المشكوك فيه. هذه المرّة، يمتلك الرجل مقدّرات تنفيذ سياساته من دون الخوض في معارك في الكونغرس أو المحاكم. كما أنّ ضعف السلطة القضائيّة أمام الرئيس المنتصر، ظهرت بمجرّد فوز ترامب، إذ إنّ وزارة العدل أسقطت الملاحقات التي كانت تُعدّها ضدّه. لكنّ ترامب، وخلافاً لرؤساء سابقين، لم يَعِد طرفاً عربيّاً بأنّه سيحزم أمره في الولاية الثانية إزاء اللوبي الإسرائيلي.
ما هي مكامن النظرة السلبيّة أو الإيجابيّة لترامب نحو إسرائيل واليهود وتأثيرها على مواقفه؟ على الصعيد الشخصي، وبناءً على كلامه، لا شكّ في أنّ الرجل عِرقي أبيض ومعادٍ اجتماعياً لليهود من دون أن يحمل عقيدة، مع الصهيونية أو ضدّها، مع اليمين أو ضدّه. هو يقرّب اليهود إليه، لكنْ بسبب نظرته العدائيّة التي تبالغ، بحسب النظرة اللاسامية التقليدية، في نفوذ اليهود وقدراتهم. هو يقرّع اليهود دوماً وليس هناك من حملات ضدّه؛ لأنّ معاداة السامية مسموحة إذا كان الشخص موالياً لإسرائيل. وتختلط عند ترامب النظرة السلبية ضدّ اليهود مع امتعاضه ونقمته من نتنياهو بسبب تبكيره في تهنئة بايدن في الانتخابات الرئاسية الماضية. ترامب لا يغفر، وهو نشرَ رسالة ودّ (ذليلة) من محمود عبّاس فقط كي يرسل إشارة سلبيّة لنتنياهو. وترامب مدين لمريم أديلسون (أرملة شلدون) التي أغدقت التمويل عليه، كما أغدق زوجها عليه التمويل في الانتخابات الأخيرة. والثنائي أديلسون يرصدان المليارات لدعم قضيّة الصهيونية والاستيطان. وهناك حديث جدّي أنّ صفقة تمّت بين ترامب وأديلسون من أجل رعاية أميركا في عهد ترامب، ضمّ الضفّة ووضعها تحت السيادة الإسرائيلية الرسمية.
عاقب العرب الأميركيون كامالا هاريس في الانتخابات الماضية، بسبب حرب الإبادة التي كانت الإدارة شريكة فيها، تماماً كما كانت شريكة في العدوان على لبنان. كانت المجموعة الناخبة العربية تستهدف إيصال رسالة حازمة حول ضرورة محاسبة إدارة بايدن ونائبة الرئيس على حرب الإبادة التي لم يشهد العرب الأميركيون مثيلاً لها على مرّ إقامتهم في هذه البلاد (وأدّى اللبنانيون الشيعة دوراً نافذاً في تأليب الرأي المحلّي ضدّ بايدن وهاريس مع أنّهم أفرطوا في تصديق وعود ترامب). والمفارقة أنّ ترامب الذي هدّدَ، لا بل وعدَ، في حملة انتخابات الرئاسة الماضية، بحظْر دخول المسلمين إلى أميركا، تغيّر هذه المرة ومدَّ جسوراً وشكّل لجنة مختصّة بالتواصل مع العرب الأميريكين والمسلمين. الحزب الديموقراطي لم يُعِر اكتراثاً لمشاعر العرب والمسلمين وحساسياتهم، لا بل إنّهم منعوا الفلسطينيين من التحدّث في المؤتمر الوطني الديموقراطي. واشتهر ذلك المقطع الذي قامت فيه هاريس بتوبيخ العرب الأميركيين على احتجاجاتهم ومقاطعتهم لها أثناء إلقائها خطبة. وزاد من الاستفزاز استفزازاً أنّ الإدارة الأميركية لبايدن لم تنفكّ تَعِد على مرّ سنة وأكثر بأنّها تعمل جاهدة للتوصّل إلى وقف النار في غزة - وهذا لم يحصل طبعاً. أمّا ترامب، فاستعان بوالد صهره كي يعقدَ جلساتِ استماعٍ مع العرب الأميركيين والمسلمين، وقد وعد فيها بوقف الحروب في لبنان وفلسطين (من دون أن يقدِّم شيئاً محدداً).
وقد يبرز صراع في إدارة ترامب بين اللبناني والد صهره الذي ينقل وجهة نظر متفهّمة لمشاعر العرب، وبين جاريد كوشنر الذي لا يفهم إلّا لغة العنف الصهيوني والمال الخليجي. ومِن المستبعد أن يفوز بولس اللبناني على كوشنر، مع أنّ إدارة ترامب أوضحت أنّ كوشنر لن يعمل من مكتب في البيت الأبيض، خلافاً للولاية الأولى. لكنْ، من المؤكد أنّ ترامب سيستعين به للتواصل مع حكام الخليج الذين يكنّون له، رغم تعصّبه اللّيكودي، كلّ الاحترام والود، وأغدقوا على صندوقه الاستثماري، المليارات.
الصراع الآخر الذي سيدور، سيكون بين النزعة الانعزالية التي تبرز باضطراد داخل الحزب الجمهوري، والتي يعبّر عنها ترامب مفتخراً بأنّه لم يُشعل حروباً خلافاً للديموقراطيين؛ وبين دُعاة التدخّل الخارجيّ وضمان أمن إسرائيل الذي يُترجَم دائماً بمزيد من الحروب والعدوان. الناس في فريق الانعزالية سيضغطون على نتنياهو من أجل إنهاء ملف الحروب المشتعلة، كما أن اللقاء الذي عقده إيلون ماسك، مستشار ترامب، مع البعثة الديبلوماسية الإيرانية في نيويورك، يؤشّر إلى رغبة ترامب في التوصل إلى اتّفاقٍ ما مع حكومة إيران. وهذا سيكون متوازياً مع رغبة ترامب في التوصل إلى اتّفاق مع كوريا الشمالية في الولاية الأولى، لكنّ الدولة العميقة ستكون بالمرصاد وستمنع توجّهات التودّد نحو أعداء أميركا التقليديين. كما أنّ اللوبي الصهيوني سيضغط بقوّة من أجل منْع ترامب من التوصّل إلى اتّفاق نوويّ جديد، وإنْ كان أكثر تزمّتاً من الاتفاق في عهد أوباما (رفض بايدن كلّ محاولات الحكومة الإيرانية لتجديد الاتفاق النووي).
قد يقول قائل إن التعيينات في مجال السياسة الخارجية والأمن القومي تُثير القلق الشديد بسبب حمْل أصحابها عقائدَ يمنية صهيونية إسلاموفوبيّة متطرّفة. لكنْ، هل يختلف اليمين المتعصّب عن اللّيبرالي، مثل بلينكن، الذي لا يمكن تفسير سياساته من دون اللّجوء إلى نظرية التفوّق العِرقي والصهيونية الإبادية؟ الفارق بين اليمين واللّيبرالية في أميركا، بالنسبة إلى السياسة الخارجية، هو فارق في اللّغة المستعمَلة، وفي الخداع الذي يلجأ إليه اللّيبراليون من أجل طمس نواياهم الاستعمارية العنصرية. ردّ وزير خارجية ترامب المعيّن حديثاً، السيناتور ماركو روبيو، على الاعتراضات التي صاحبت تعيينه (بسبب مواقفه المتطرّفة)، فقال إنّ الرئيس وليس وزير الخارجية هو الذي يصنع السياسات. وكان هذا صحيحاً في ولاية ترامب الأولى، لكنّه في ولايته الثانية يستطيع أن يضغط أكثر ضدّ أجندة الدولة العميقة التي عرقلت مساعيه من أجل إضفاء المزيد من العلاقات السِّلمية مع أعداء أميركا التقليديين. يُجمِعُ الحزبان بقيادتيهما التقليدية على ضرورة الحفاظ على العداء، خصوصاً ضدّ أعداء إسرائيل الموْصومين دوماً بالإرهاب.
التحليل الذي يفترض إدارةً أميركية أسوأ من سابقتها، يصحُّ في معظم الأحيان. فكلّ رئيس أميركي كان أكثر مناصرةً لإسرائيل من سلفه (باستثناء جورج بوش ووزير خارجيّته، جيمس بيكر. الاثنان كانا أكثر شجاعةً في مواجهة اللوبي من كلّ الإدارات السابقة واللاحقة). لكنّ شخصية ترامب ومزاجه، بالإضافة إلى السلطة الكبيرة التي عادَ بها، سيُتيحان له الفرصة لإحداث تغييرات في السياسة الخارجية - لو أرادها. لكنّ الحقّ العربي ليس ضاغطاً في السياسة الأميركية: كانت دول الخليج تضغط بالحقّ الفلسطيني، في حدوده الدنيا، وهي توقّفت بعد عام 1990 عن المطالبة بتعديل السياسة الأميركية. ترامب سيستمرّ في طلب مشتريات أسلحة باهظة الثمن من أنظمة الخليج؛ لأنّ ذلك هو العالم الوحيد الذي يقرّب الطرفَين (لم يُخفِ ترامب احتقاره للدول العربية، خصوصاً عندما جلس غلى جانب محمد بن سلمان وعرض مشتريات الأسلحة من قِبل السعودية، وعبْر لوحات كبيرة جلبها الوفد السعودي معه كي يُبهر ترامب). المنطقة مُقبلة على تغييرات كبيرة، والهجمة الصهيونية لن تتوقّف، ومن غير المأمول أن يقف الرئيس الأميركي إلى جانب الحقّ والإنسانيّة. لا يكون رئيساً أميركيّاً لو فعلَ ذلك.
كاتب عربي